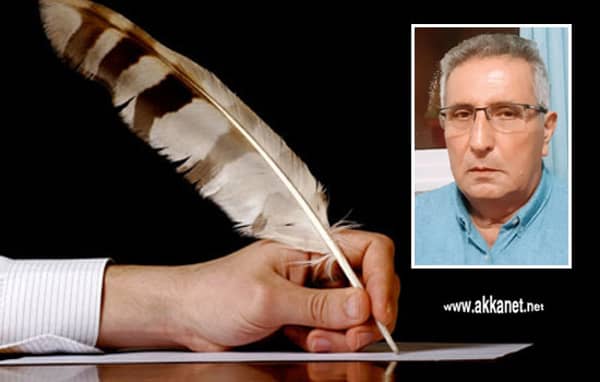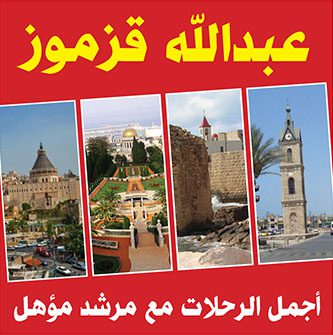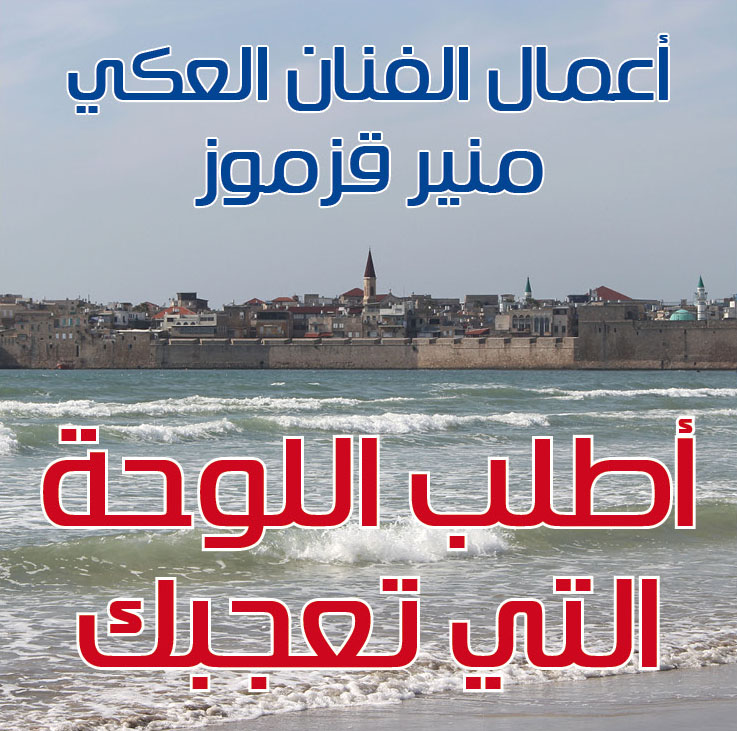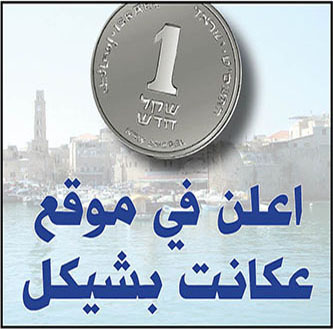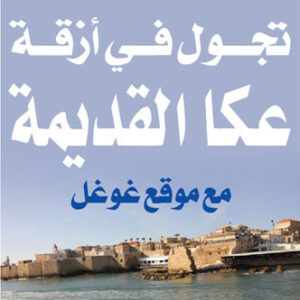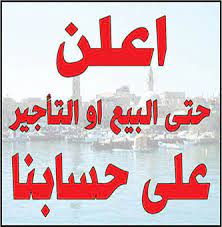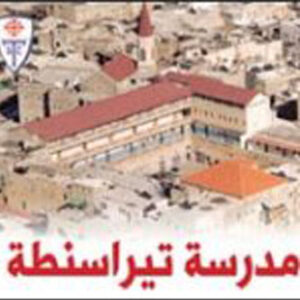بقلم: رانية مرجية
1. مقدّمة: الشاعر الذي يكتب من داخل الجرح
في المشهد الشعري العربي الذي تضجّ فيه الأصوات بالشكوى والحنين، يبرز اسم أسامة ملحم كصوتٍ مختلف، يكتب من داخل الجرح لا من حوله.
هو شاعر فلسطيني من كفر ياسيف في الجليل، انبثق من بيئةٍ تُمزج فيها الذاكرة بالمنفى، والوجع بالحلم.
تجربته ليست بحثًا عن البطولة ولا النواح، بل تأمّل في هشاشة الإنسان أمام القسوة، في جغرافيا لا تعرف السكينة.
أسامة ملحم لا يكتب الشعر ليُعبّر، بل ليُطهّر.
لغته كائنٌ حيّ يتنفّس الألم ويعيد ترتيبه، لا ليُثير الشفقة بل ليُنتج وعيًا جديدًا بالحياة.
2. سيرة موجزة دقيقة
وفق ما توثّقه المصادر الأدبية الموثوقة، يُعدّ أسامة ملحم من أبرز الأصوات الفلسطينية في قصيدة النثر المعاصرة.
هو مدير مجلة “ميس” الثقافية الدورية، وعضو في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين.
صدرت له عدة مجموعات شعرية من أبرزها:
سادر – باب الريح – جرة ماء ورد – حبل الرحيق – رسائلها التي ظلت في الدولاب – الرساؤلات – كطاوي ثمان – والشيء الأسود الكبير (عمل مسرحي).
تتناول أعماله مفاهيم الاغتراب، الصمت، العزلة، وحتمية البحث عن النقاء وسط الخراب
يشارك ملحم بانتظام في أمسيات أدبية فلسطينية وعربية، وله حضورٌ نقديّ مؤثر في المشهد الثقافي داخل فلسطين التاريخية، وخاصة في الجليل وحيفا ورام الله.
3. شعره بين الحزن والفكر
في عالم أسامة ملحم، الحزن ليس انفعالًا، بل منظومة معرفة.
هو لا يكتب البكاء، بل يكتب ما بعد البكاء.
في نصوصه، يتحول الألم إلى بنية فكرية دقيقة، إلى مختبر لغويّ يُجري فيه الشاعر تجاربه على الروح.
في ديوانه «الرساؤلات» — كما تذكر الدراسات النقدية المنشورة في الاتحاد الثقافية وديوان العرب — يواجه ملحم السؤال الأخلاقي والوجودي معًا.
فيقول:
“كل هذه الغلال في الحقول، ولا لقمة تسدّ جوع جائع؟”
ليعيد صياغة المأساة الفلسطينية والعربية في شكل سؤالٍ بسيطٍ وصاعق في آنٍ واحد.
هنا الحزن ليس حالة وجدانية، بل تشخيص فلسفي للظلم الإنساني.
هو شاعر الاحتجاج الصامت، الذي لا يصرخ بل ينزف بمنهجية شاعرٍ يعرف أن الغضب لا يحتاج ضجيجًا.
4. بين الغابة والرائحة: فلسفة البقاء
في نصّه «حين خرجنا من الغابة»، تتجلى فلسفة ملحم بكثافتها النادرة:
“حملنا أغصان الإزدرخت نمحو بها آثارنا، كي لا تلاحقنا الوحوش… فاستدلت علينا عن طريق الرائحة.”
إنها استعارة لا عن الغابة فقط، بل عن حالة الوجود البشري ذاته.
فالغابة هنا ليست الطبيعة، بل الغريزة، الخوف، الذاكرة، والماضي الذي يلاحقنا برائحةٍ لا تزول.
الوحوش ليست خارجنا بل فينا، والرائحة هي الحزن المتجذّر في خلايانا.
إنه نصّ يختصر تجربة الإنسان الحديث في محاولته للنجاة من نفسه.
بهذا المعنى، يُمكن القول إن أسامة ملحم هو مهندس الغابة الداخلية، شاعرٌ يُعيد صياغة علاقتنا بما نظن أننا تخلّصنا منه، ليذكّرنا بأننا نحمل آثار الوحش فينا، حتى ونحن نبحث عن الضوء.
5. لغة ملحم: البناء على الحافة
لغة ملحم مجرّدة ومجسّدة في آن.
هو شاعر يُدير الاقتصاد اللغوي ببراعة، فيكتفي بالجمل القصيرة ذات الإيقاع الداخلي، لكنه يحمّلها معاني متشعّبة.
يستبدل الزخرف بالصفاء، ويجعل الصمت جزءًا من القصيدة.
كل كلمة عنده وحدة وجودٍ صغيرة — تحتمل الألم والفكرة والرمز معًا.
النقاد يرون في لغته “لغة هندسية”، تشيّد الجملة كما يُشيّد البنّاء الحائط؛ لا ليتباهى بارتفاعه، بل ليحمي ما وراءه من الانهيار.
6. الحزن كقيمة معرفية
أسامة ملحم لا يخاف من الحزن، بل يعامله كأستاذٍ عظيم.
يمنح الألم وظيفةً معرفية: يعلّمنا كيف نرى أنفسنا خارج الصور الزائفة.
يكتب كما يتأمّل المتصوف، وكما يُحلّل الفيلسوف.
ومن هنا يتفوق شعره على كثير من القصائد التي تُكرّر الحزن كموسيقى، بينما هو يجعله بنية فكرية تشبه المختبر الداخلي الذي تتفاعل فيه “الروح، اللغة، والذاكرة”.
7. شاعر خارج الألقاب
يُقاوم أسامة ملحم فكرة “اللقب”.
يرى أن الشعراء الكبار لا يحتاجون إلى نعوتٍ تضخّمهم، لأن القصيدة هي اللقب الوحيد الباقي.
في زمن امتلأت فيه الساحات بـ”شعراء الفلاشات”، يظلّ ملحم شاعرَ الظلّ، والهدوء، والصدق.
لا يلهث خلف المجد بل يكتبه بهدوءٍ يُربك من يقرأه.
إنه شاعر الزهد الجمالي: لا يتزيّن بالكلمات، بل يطهّرها.
8. أثره في القارئ العالمي
ما يجعل شعر ملحم صالحًا للقراءة عالميًا هو أنه يكتب الإنسان لا الجغرافيا فقط.
قصيدته قابلة للترجمة لأنها لا تعتمد على المحلّيّة وحدها، بل على التجربة الوجودية العميقة: الخوف، الوحدة، الصبر، والبحث عن معنى الحياة في زمن الانكسار.
هو شاعر فلسطيني بالهوية، إنساني بالجوهر.
يذكّرنا شعره بأن الألم ليس حكرًا على مكان، بل هو لغة مشتركة بين البشر، وأن القصيدة لا تحتاج وطنًا لتكون صادقة، بل تحتاج ضميرًا حيًّا يعرف أن يقول الحقيقة دون صراخ.
9. خاتمة: شاعر في زمن الضجيج
في زمنٍ تتكاثر فيه النصوص وتتضاءل فيه المعاني، يظلّ أسامة ملحم استثناءً حقيقيًا:
يكتب من منطقةٍ دقيقةٍ بين الوعي والوجدان، بين الرمز والواقع، بين اللغة كأداة، واللغة كقدر.
هو شاعر لا يُمكن أن يُترجم حرفيًا، لأن ما يكتبه لا يقع في اللغة فقط، بل في الفراغ بين الكلمات.
حين نقرأه، لا نخرج بمتعة فنية فحسب، بل بشعور أننا عُدنا إلى ذواتنا، وأن الشعر ما زال قادرًا على أن ينقذ ما تبقّى من الإنسان فينا.
رانية مرجية
كاتبة وناقدة فلسطينية