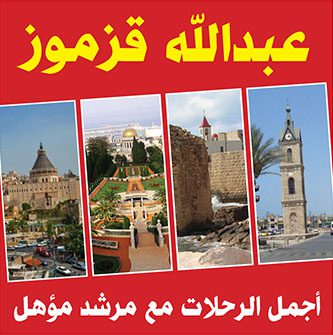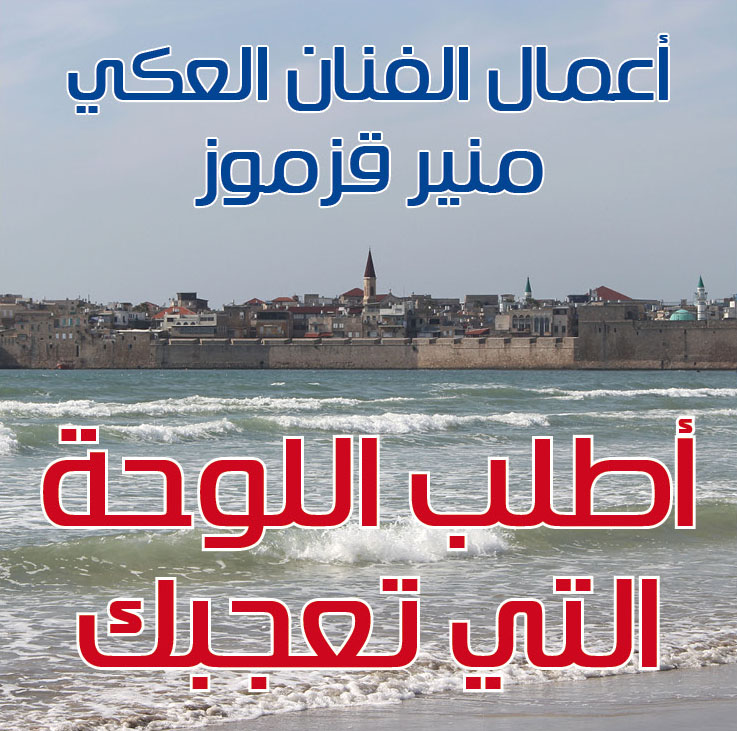الأرض الحرام
في الليل اللائل يتسلّل الصقيع من ثقوب الخيام، ليحفرَ ملامحه في كوم لحمٍ التصق بآخر ما تبقّى له من جسدٍ غلّفته حرارة الدموع. يزأر الرعدُ فتعوي بطونهم، ترتعد أوصالهم وتصطكّ أسنانهم غازلةً سيمفونيّة البرد بالشقاء. تلك السيمفونيّة يُباغتها صريخ الرضيع عندما تجفّ ينابيع النهدين.
حتى طعم كسرة الخبز التي اقتسمتها الأم مع طفليها منذ يومين ضاع في حلوقهم واحترق في بطونهم.
تتعالى صرخات بكاء الرضيع من شدّة الجوع وتزداد ثقوب الخيمة بالاتساع… يسكت للحظات من التعب، ثم يعود ليبكي من جديد ويستجدي حليب أمه المنقطع. تحتضنه أمه بحرقة وتبكي هذه المرة بلا دموع.
حتى بنات العين الساخنة جفّت من المآقي. وتركت البردَ ينهشُ في جسد الأم والأطفال.
– هيّا بنا يا حسّان فلنذهب للبحث عن بعض الماء والطعام، علّنا نجد لأمي ما تسدّ به جوعها كي ترضع أخانا الصغير محمد.
هذا ما همس به نوّار ابن العاشرة لأخيه حسّان الذي يصغره بثلاثة أعوام مستغلا غفوة أمه وأخيه الصغير.
عانق نوّار أخاه حسّان ثم خرجا من الخيمة يشقّان الصقيع بجسديهما الضئيلين بحثا عن بعض الطعام والشراب.
بين أشجار الزيتون اُفترِشت آلاف الخيام المرقّعة بالبرد والحرمان… خيامٌ غزاها الجوع والنسيان في مخيّم أطمة للاجئين السوريين.
هناك على حافة الوطن المنسيّ يتزاحم أكثر من مئتي ألف لاجئٍ سوريّ -جزءٌ كبيرٌ منهم فلسطيني الأصل- توزعوا على اثنين وعشرين مخيّما أقيمت بشكلٍ عشوائي على خط الحدود التركيّة السوريّة حيث أجبرتهم الحرب في سوريا على ترك أوطانهم ومغادرة منازلهم للتمسّك بخيط حياة في مخيّمات اللاجئين تحت ظروفٍ صعبة وأوضاعٍ مزرية. فهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم ولا يجدون لأنفسهم أماكن أخرى آمنة. وتجدهم يواجهون العديد من الصعوبات والنقص الشديد لاحتياجات الحياة الأساسيّة.
مخيّم أطمة هو أحد هذه المخيّمات التي تحوي آلاف النازحين في ريف إدلب. حيث تمّ انشاؤه على مسافة 15 كم من بوابة باب الهوى (جيفة غوزو) الحدودية قرب بلدة الريحانيّة (ريحانلي) التابعة لولاية هاتاي التركيّة. يحصل المقيمون في المخيّم على احتياجاتهم الأساسية، من المساعدات الخارجية التي تأتيهم كل أسبوع أو أسبوعين من المؤسسات الانسانية. ويقيم أصحاب الوضع المادّي الجيّد نسبيّا في غرفٍ من الطين بنوها بأنفسهم، بينما يكافح الفقراء منهم من أجل البقاء على قيد الحياة في الخيام.
أطفالٌ وجوههم مشعّة بالنور، ثيابهم مرتّبة ونظيفة. تغمرهم أحضان والديهم بالحبّ والحنان… تارةً يدرسون وتارةً يأكلون الحلوى دون خوفٍ أو ملل… يلعبون بألعابهم الدافئة وسط حكايا الجدّة التي تسافر بهم إلى عالم البطولة… وهناك تجد المغامرين يتحدّون أحلام المستحيل لتصبح خيولا تعدو معطّرةً برياحين الوطن.
تلك اللوحة البهيّة نهشتها ذئاب الحرب، استبيحت الدماء ولوّثت المياه بسم الأفاعي… تشرّد الأطفال اليتامى والنساء الثكالى وبعضُ الأجسادِ التي بقيت على قيد شهيق وزفير.. ومنهم من بقي وحيدا فاقدا لكل أفراد عائلته في الحرب، انفجر الوطن بصرخات الألم والبكاء ودفنت أحلام الأطفال الورديّة في بئرٍ من الشقاء…
بردٌ وصقيع، عواصفُ مطريّة تجتاح المكان فتغرق الخيام في الطين ويمسي العديد بلا مأوى… سوء التغذية، الربو والحمّى، أمراضٌ تكتسح المكان… أطفالٌ يصرخون من شدة الألم والبرد. ومن وجد منهم صندوقا كرتونيا يتكوّر فيه كأنّه وجد بيتا يحنّ عليه بقليل من الدفء وشيءٍ من النوم.
أمّا مخاض الأمهات الحوامل فيخجل أن يزيد فوق ألمهم ألما…ومع كلّ صرخة مخاضٍ تتفجّر حياةٌ كُتب لها الشقاء.
يمتدّ افتراس الذئاب، وكأنّ الحرب في الوطن لا تكفي. إذ يحتدّ النزاع والقتال حتى يطال المخيّم عدّة صواريخ من العمليّات العسكريّة بين الجيش التركي والقوّات الكرديّة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى على الحدود السورية التركيّة. فيلقى بعض اللاجئين في مخيّم أطمة مصرعهم وأغلبهم من الأطفال.
عائلاتٌ بريئة سلختها الحرب عن وطنها، لتلجأ إلى نزيف عذابٍ لا يرحم… هنا يفقد اللجوء معناه وتصبح كل الأراضي محرّمة على الإنسان في زمن انعدم فيه الضمير واندثرت فيه الإنسانيّة والعدالة من الوجود.
وعندما يُسدل الليل ستاره على المخيّم تتوه النجوم كلّما أعلن الشيخ عن صلاة جنازة…
كل تلك المشاهد يسترجعها نوّار وحسّان في رحلة بحثهما عن الطعام والشراب وسط المخيم… يمشيان في ظلمة المكان، بردٌ وجوعٌ يلتهم جسديهما الهزيلين… ساعتان من البحث لم يجدا فيها حتى الفتات، فحال الناس في الخيام ليس أفضل من حالهم.
حسّان يبكي ويقول لأخيه: لا أشعر برجليّ من شدّة البرد.
عندها أجلس نوّار أخاه على أحد الحجارة الكبيرة، دلّك له رجليه لكي يبعث بهما بعض الحرارة وعندما انتهى قال له:
– لنا الله يا أخي… هيّا بنا لنرجع إلى خيمتنا. على الأقل إن متنا سنموت في حضن والدتنا.
وما أن همّا بالرجوع إلى خيمتهما، حتى سمعا فجأةً صوت عجوز تبكي بجانب خيمتها، ولمحاها ترفع يديها إلى السماء وتقول:
– خذني إليهم يا الله.
ذهب حسّان ونوّار إليها، اقتربا منها ثمّ قال لها نوّار: لماذا تبكين يا جدّة؟
– آهٍ يا ولديّ! منذ يومين توفي آخر أحفادي هنا، وفي الحرب فقدتُ جميع أفراد عائلتي… لم يتبقَّ لي أحدٌ سوى الله. مسحت الجدّة دموعها، وأردفت قائلةً: وأنتم يا أحبّائي، ما الذي يجعلكما تسيران لوحدكما في الليل؟!
وعندما قصّ نوّار وحسّان عليها قصتهما، حضنتهما العجوز بقوة، دخلت إلى خيمتها لبرهة ثمّ خرجت محمّلةً بقطعة قماشٍ فيها بعض الخبز والتمر وزجاجتيّ ماء، وملابس طويلة لأطفال صغار وغطاء للنوم.
– خذوا هذا الطعام، هو كل ما تبقّى لي. وهذه الملابس كانت لأحفادي رحمهم الله، و…
وقبل أن تنهي حديثها، قاطعها نوّار قائلا:
– ما رأيك يا جدّتي أن نساعدك في جمع أغراضك ثمّ تأتين للعيش معنا في خيمتنا. عندها
اغرورقت عينا العجوز بالدموع وقالت: لا يا بنيّ! لا أريد أن أزيد الحِمل عليكما وعلى والدتكما.
قال حسّان: بالعكس يا جدّتي سنكون عائلة واحدة نساعد بعضنا بعضا.
وعندما وافقت الجدّة العجوز على ذلك الاقتراح، حمل نوّار وحسّان معها باقي أغراضها، وعادوا إلى خيمتهم. عندما رأتهم الأم فرحت بعودتهما بعد أن كانت تبكي خوفًا عليهما حين استيقظت من غفوتها ولم تجدهما بجانبها.
رحّبت بالجدة وشكرتها على حسن أخلاقها، وقالت لها: منذ الآن أنت أمي وجدّة أطفالي. وسنساعد بعضنا دوما…والحمد لله على كلّ حال.
أسكتت العائلة عطشها وجوعها بالماء والطعام الذي أحضرتهما الجدّة معها. التحف الرضيع صدر أمه ورضع من عرقيها اللذين دبّ الحليب فيهما من جديد.
“ويمّر بي طيفها
وتسكن الأحلام
جميلةٌ وأحبها
واسمها شام”
– أبي هيّا أسرع… نحن ننتظرك في السيارة… لا تبحث عن لعبة حسّان الآن. في المذياع يتحدثون عن قصفٍ قريب لبلدتنا… هيّا أسرع!
– حسنا يا بنيّ، إنّي آتٍ إليكم.
فجأةً صُمّت الآذان برعد الصواريخ التي أشعلت الدماء، النيران والدخان. وأغنية شامٍ تتراقص في المكان.
استفاق نوار من حلمه مفزوعًا باكيًا بعد أن غفا على صخرةٍ صمّاءَ أحنّ عليه من قلوب البشر.
أخرج من جيبه صورة والده التي تلازمه أينما ذهب. قبّلها وعيناه تذرفان الدموع بغزارة. مسح دموعه بذراعه، نادى على حسّان الذي كان يلعب في بركة الوحل مع أترابه من أطفال المخيّم… اقترب منه وهمس له:
– الليلة كما خططنا…
– حسنًا يا أخي.
“أمي الحبيبة! عندما تقرئين هذه الرسالة سنكون قد رحلنا عن المخيّم… سنبحث عن عمل كي نحضر لك الطعام والملابس الجديدة… لا تقلقي علينا يا أمي… سنرجع قريبًا. نحبّك جدا….نوّار وحسّان”.
قرأت الأم الرسالة ودموعها تنساب بحرقة على وجنتيها، قلبها سينفجر من الحزن والخوف عليهما.
– آهٍ يا طفليّ الصغيرَين أين ذهبتما؟! كيف سيغمض لي جفنٌ وأنتما لستما بجانبي.
رأتها الجدّة على هذه الحالة، اقتربت منها وعانقتها ثمّ قالت لها:
– لنا ولهما الله يا هناء… سأدعو الله أن يحفظهما ويرجعهما إلينا سالمين.
في تلك الليلة المقمرة رحل نوّار وحسّان عن المخيّم وهما يرتديان ملابس أحفاد الجدّة المرقّعة فوق ملابسهما المهترئة. وفي حقيبة ظهر حسّان ثمرتان، رغيف خبزٍ وزجاجة ماء. خرجا من المخيم وأخذا يمشيان مسافة طويلة في السهول. الخطر يحيط بهما في الليل الحالك، أصوات الذئاب والضباع تجتاح المكان. يخاف حسّان ويبدأ بالبكاء. عندها يضع نوّار يده على فمّ أخيه ويهمس له:
– كن شجاعا ولا تخف…اقتربنا من الوصول.
أمسك نوّار بيد أخيه وأسرعا الخطى حتّى وصلا مزرعة قطنٍ تتوسطها لوحةٌ خضراءُ كُتِب عليها بالعربية والتركيّة “الريحانيّة ترحّب بكم”. قطف الطفلان بعض القطن وحشواه داخل ثيابهما وحذاءيهما حتى شعرا ببعض الدفء. افترشا الأرض والتحفا السماء، ثمّ ناما كالقتيلين من التعب.
في الصباح استيقظ نوّار مذعورًا، إذ أنّه لم يجد أخاه حسّان بجانبه… صرخ مناديا باسمه، لكن ما من مجيب. خاف عليه ولام نفسه: “أنا السبب، من المؤكد أنّه اختطف أو حلّ به مكروه ما…”
مشى نوّار في المزرعةِ تائه الخطوات محترق القلب، باحثًا عن أخيه الصغير… وبينما هو كذلك وإذ بشيءٍ يهجم عليه من الخلف ويطرحه أرضًا، ثمّ ينفجر من الضحك…
– ماذا تفعل أيّها الشقيّ… وأين كنت؟! لقد خفت عليك كثيرا.
عانق حسّان أخاه نوّار ثم أعطاه زجاجة حليب.
– خذ اشرب… إنّه طازج… الآن حلبته من البقرة.
– من أين لك هذا وكيف؟!
– لا تقلق! لم أعد صغيرا… استيقظتُ قبلك ورأيتك ما زلتَ غارقًا في النوم. فقلتُ في نفسي: سأبحثُ عن طعامٍ ريثما تستيقظ… مشيت ومشيت وسط مزرعة القطن، وفي نهايتها وجدتُ بوابةً حديديّة عالية ذهبية اللون. وبجسدي الهزيل نجحت بالتسلّل منها، وهناك رأيتُ العجب.
– صاح نوّار متلهّفا: أخبرني ماذا رأيت؟
– رأيتُ قصرا فخما كبيرا حوله أشجار كثيرة من الفاكهة… حظيرة أبقارٍ وأغنامٍ، واسطبل خيولٍ يتوسطان حديقة القصر الشاسعة. لكنني لم ألمح إنسانًا هناك. عندها انتهزتُ الفرصة دخلتُ الحظيرة وحلبتُ إحدى البقرات، ثم وضعتُ الحليب في زجاجة الماء الفارغة التي كانت معي… وجئتُ إليك مسرعًا. بعدما شربا الحليب الطازج، قال حسّان لأخيه: هيّا بنا نرجع لحديقة القصر، نقطف بعض الثمار لنسدّ بها جوعنا.
– وإن أمسكَنا أحدهم؟
– لا تخف لن يحصل لنا شيء.
– هيّا بنا إذن… صاح نوّار.
ركضا مسرعين إلى هناك، تسلّلا من البوابة ثمّ تسلقا شجرة التفاح، قطفا بعض الثمار وأخذا يأكلانها بنهم. لكنّ صراخ رجل كهل يتقدمه بطنه العريض أفسد متعتهما في الأكل.
– ماذا تفعلانِ هنا أيّها السارقان؟! انزلا فورا عن الشجرة…
نزل نوّار وحسّان عن الشجرة وهما يرتجفان خوفًا.
– أرجوك يا عمّ لا تسلّمنا للشرطة.
– أيّها اللصان سآخذكما إلى مشرف القصر وهو سيسلمكما بنفسه إلى الشرطة.
أدخل الحارس الطفلين إلى داخل القصر ثمّ نادى على المشرف هناك:
– يا عبد الرحمن! تعال وانظر ماذا سنفعل بهذين السارقين اللذين وجدتهما يسرقان التفاح من الحديقة.
ما هي إلّا لحظات حتى جاء المشرف. عندها أصابت الدهشة الطفلين ليس لفخامة أثاث القصر وتحفه الجميلة، وليس خوفا من مصيرهما الآتي… انّما للصاعقة التي نزلت أمام عيونهما. نفضا نفسيهما من يد الحارس وأخذا يتراقصان حول مشرف القصر ويردّدان بغبطةٍ وفرح: أبي…أبي مازلتَ حيّا…الحمد لله…الحمد لله!
استغرب الحارس كلامهما، كما حملق المشرف مندهشا بإنكارٍ مزّق فرحة الطفلين. حيث قال لهما: من أنتما؟! وماذا تريدان؟! أنا لا أعرفكما…
وأردف الحارس ساخرا: ليسا سارقين فقط بل محتالان أيضا.
عندها أخرج نوّار من جيبه الصورة وتوجّه نحو أبيه قائلا:
– كلا… انظر يا أبي انّها صورتك معنا، نحن عائلتك… أمي وأخي الصغير تركناهما في المخيم وجئنا للريحانية بحثا عن عمل.
نظر عبد الرحمن باستغرابِ إلى الصورة وقال في نفسه: يا الهي! كم يشبهني هذا الرجل… كيف حدث هذا كيف؟!
هنا همّ الحارس بإخراجهما من القصر… لكن مشهد الدماء، والدخان الصراخ والبكاء والركام عاد ليظهر أمام عيني المشرف عبد الرحمن. هذا المشهد يعود ويراوده في الصحو والأحلام كل فترة من الزمن.
أغمض عينيه ثم فتحهما بسرعة معترضا الحارس ومشفقا على الطفلين.
– دعهما لي، سأبحث في أمرهما جيدا… هما طفلان صغيران بلا مأوى. وأنا سأستأذن صاحب القصر الأستاذ سالم كي يعملا هنا في المزرعة فترةً بسيطة، وسينامان في القبو الصغير أسفل القصر.
عندها رمقهما الحارس بنظرة سخط، واختفى من المكان. بينما أعدّ لهما عبد الرحمن طبقين من الطعام.
– هيّا يا صغيران! كُلا كل هذا الطعام… انه لذيذ لقد صنعته بنفسي فأنا طباخ ومشرف هذا القصر.
شكره نوار وقال له: من المؤكد يا والدي أنّ طعمه لذيذ… لقد كنت أشهر الطباخين في الشام.
استغرب عبد الرحمن ما قاله الصغير، دمعت عيناه، ابتسم لهما، ثمّ قال في نفسه:
أيعقل أنني الشخص الموجود في الصورة، أيعقل أن تكون لي عائلة…ماذا عن الشبه الواضح بيني وبين الصغيرين؟! لا أدري… ساعدني يا الله لمعرفة الحقيقة… قلبي رأف لهذين الطفلين الجميلين، ولكن لا أدري إن كنت والدهما حقا.
– ما به والدنا لا يتذكرنا، ولماذا ناداه الحارس بعبد الرحمن وهو اسمه نعيم… ما الذي يحدث يا نوّار؟!
قال حسّان لأخيه وغصّة تخترق صدره: لا أدري يا حسّان، ولكن أشكّ أنّ والدي قد نجا من براثن الحرب وفقد الذاكرة دون أن نعلم عنه شيئا… سنة كاملة كنّا نعتقد أنّه استشهد في الحرب. ولكن في نفس الوقت أخاف أن يكون هذا الشخص ليس والدي، انّما يشبهه فقط… ولكن اتمنى أن يكون هو والدنا.
– وانا أتمنى ذلك أيضا…
مرّت أيام وليالٍ اجتهد بها نوّار وحسّان في عملهما بالمزرعة وباتا صديقين للمشرف عبد الرحمن وللحارس أيضا… كما أحبهما الأستاذ سالم وعائلته وأشفق عليهما كثيرا عندما حدّثه عبد الرحمن بما جرى، وأراه الصورة.
ذات يوم نادى سالم عبد الرحمن ليتحدّث معه في موضوعٍ هام. تنهّد ثمّ قال: اعتقد أنّ ما يقوله الطفلان صحيح يا عبد الرحمن… الله رؤوف رحيم بالعباد والدنيا صغيرة يا أخي… أتذْكُر قبل سنة وجدتك ملقًى على أرض مزرعتي والدماء تسيل منك. عندها أشفقت عليك، جلبت لك الطبيب وآويتك في منزلي، وأنت لم تتذكر ما الذي حصل لك. وأنا الذي سميتك عبد الرحمن لأنك لم تتذكر حتى اسمك. ومنذ ذلك الوقت وأنت تعمل كطبّاخٍ ومشرفٍ للقصر. وما رأينا منك إلا كل خُلُق طيّب… وها هما ابناكَ مثلك.
اذهب يا عبد الرحمن واجلب بقيّة عائلتك إلى هنا… وان لم يسعك وطنك الآن ستسعك قلوبنا وهذه الأرض الطيبة…
عندما سمع عبد الرحمن هذا الكلام، ذرف دموع الفرح والشكر وعانق سالم بحرارة.
في صباح الغد سافر عبد الرحمن وولديه إلى مخيّم أطمة، وفي الطريق كان يصلّي الى الله راجيا إيّاه أن يُرجع له ذاكرته قبل أن يقابل زوجته.
شارعٌ فقط يفصلهما عن المخيّم. تتسارع دقات قلب عبد الرحمن، يبلّله العرق رغم البرد… يعود مشهد الحرب ليراوده من جديد… ما الذي يحدث لي؟! يمسك نوّار وحسّان بيديّ والدهما… وفجأةً يلمح حسّان أمه تعمل في المستوصف القريب من الشارع. يصيح: أمي أمي… يفلت من يد والده ويسرع ليقطع الشارع دون أن ينتبه للسيارة القادمة بسرعة نحوه… تتحرّك دماء الأبوة في عبد الرحمن، فيقفز لينقذ ابنه من براثن عجلات السيارة، يقذفه إلى برّ الأمان… ولكن يتلقى الضربة من السيارة المسرعة فتتفجر الدماء من رأسه وكتفه الأيمن، يسقط مغشيا عليه. يسرع سائق السيارة بنقله إلى المستوصف. بكاء وعويل نوّار وحسّان يخترق المكان…
– لا تمت يا والدي… لن نفقدك مرة أخرى…
تركض الأم نحوهما بذهول، تتسمّر أمام زوجها… تعانق طفليها بلوعة واشتياق. تقرع طبول قلبها بشدّة دون أن تنبسّ ببنت شفة. تمسك بيد زوجها الباردة… تقبّلها ثمّ ترتمي بأحضانه ودموعها الساخنة تسيل على وجنتيه… وما هي إلّا لحظات حتى ترجع نبضات قلبه للصهيل… يفتح عينيه ببطء… يراها أمامه، يبتسم ثم يتمتم: كم أشتاق إليكِ يا هناء… كم أشتاق للوطن…
بقلم: عايدة هنداوي مغربي
من مجموعتها القصصية “جرح الياسمين”