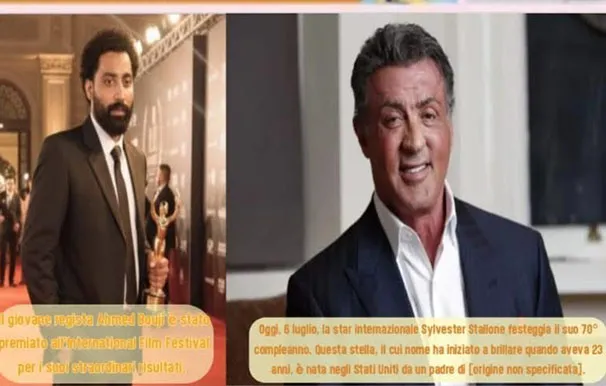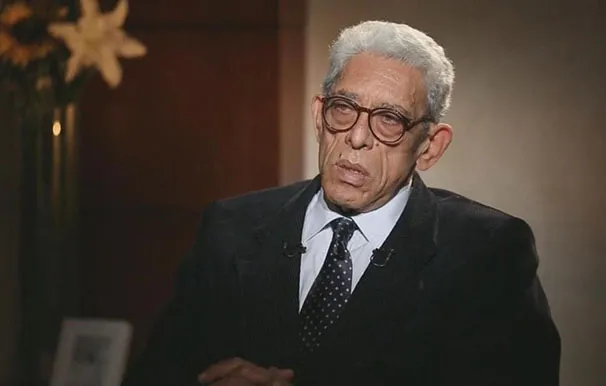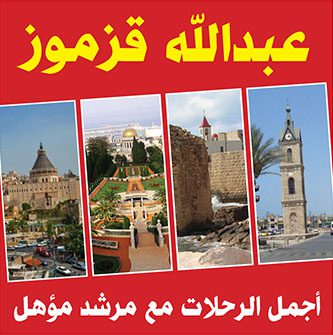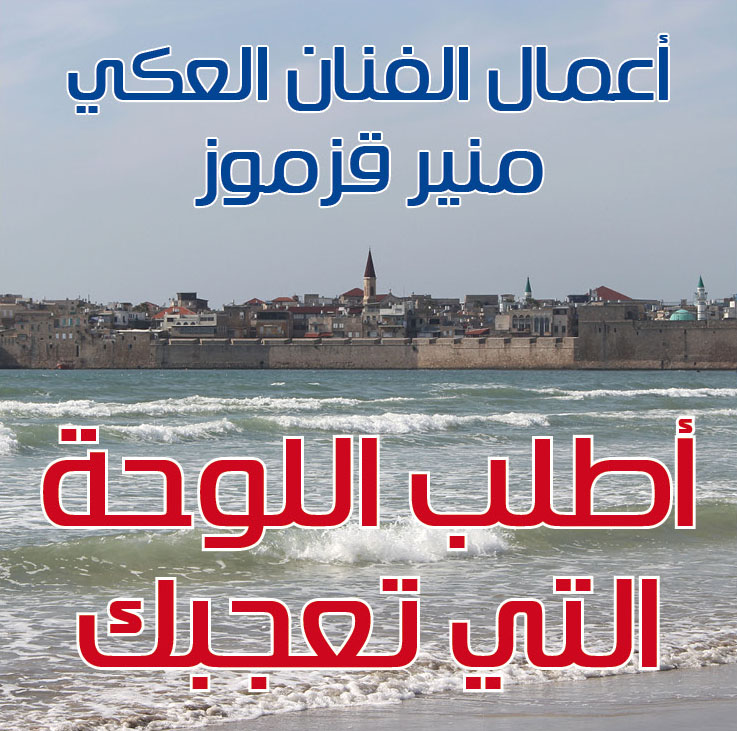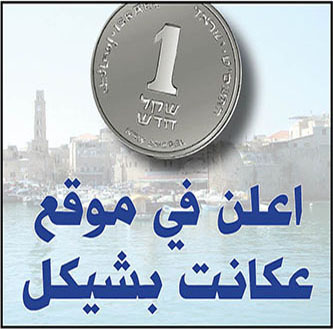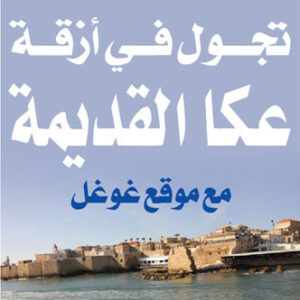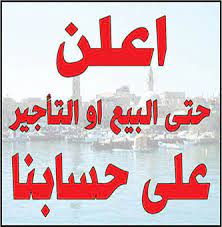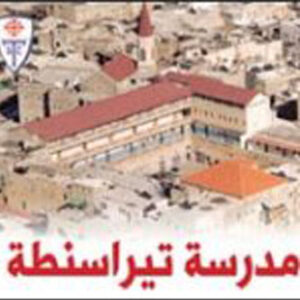**قراءة معمّقة موسّعة في لوحة عبد عابدي
نحو فهم روحي–اجتماعي–سياسي للصورة**
أولًا: اللحظة البصرية التي تتحوّل إلى سؤال الوجود
لا يمكن النظر إلى هذه اللوحة كحدث متجمّد؛ إنها لحظة تتجاوز نفسها، لحظة تحاول الإمساك ببرهة من الزمن الفلسطيني الذي لا يتوقّف عن التجدّد، برهة لا نعرف أين تبدأ:
هل تبدأ عند الرجل المنكفئ على حزنه؟
أم عند الجموع التي تتنازع على فتحة بوابة مغلقة؟
أم عند الصمت الذي يربطهما ولا يتصالح مع أيٍّ منهما؟
هنا، يتصرّف عبد عابدي كمن يصنع مرآة مزدوجة:
مرآة للذات الفردية المنهكة، ومرآة للجماعة التي تتدافع بحثًا عن نجاةٍ ما.
ثانيًا: الرجل في المقدمة… “نبوءة التجربة”
الجلوس في هذه اللوحة فعلٌ وجودي.
الرجل لا يجلس اعتباطًا؛ إنه يجلس لأنه لا مكان آخر للوقوف فيه.
كأنّ الأرض أضيق من أن تحمله، والسماء أبعد من أن تظلّل رأسه.
ملامحه ليست ملامح فرد؛ إنها تجسيد لسنوات القحط، لليأس العميق الذي لا يحتاج إلى دموع كي نفهمه.
الخطوط التي رسم بها الفنان وجه الرجل ليست خطوطًا ظاهرة فحسب، بل انحناءات تعب متوارث، تعب يشبه خطوط جذع شجرة عجوز تحمل آثار كل رياح هبّت عليها.
يداه المسترخيتان في حضنه ليستا استسلامًا، بل حكمة من عرف أن الصراخ لا يغيّر بوابة مغلقة.
أما الأطفال، فهم خلفه بطريقة ليست خلفية فقط، بل امتداد—
امتداد لجروح الرجل
وامتداد لأسئلة المستقبل الذي لا يعرف أين يضع خطوته الأولى.
ثالثًا: الجموع… “كتلة الصوت التي لا يسمعها العالم”
في الخلفية، يقدّم عبد عابدي الحشد ككيان واحد.
وجوه بلا تفصيل.
أجساد بلا حدود واضحة.
لكن أذرع مرفوعة، وأكتاف تتلاصق، وتوتر يملأ الهواء.
الحشد يتحرّك كثقلٍ واحد لا كأفراد.
وهذا مقصود:
لأن الفنان يريد أن يقول إن المأساة جماعية، والصراخ جماعي، والأمل حين يظهر يكون جماعيًا أيضًا.
الأيدي المرتفعة ليست دعاءً…
إنها احتجاج…
حاجة…
استغاثة…
توسل لفتح البوابة أو فتح القدر أو فتح الحياة نفسها.
إنهم لا يتدافعون فقط…
بل يحاولون ألّا يسقطوا من التاريخ.
رابعًا: البوابة… رمز السلطة، ورمز الفقدان
البوابة هي أقسى عناصر اللوحة.
خطوطها معدنية قاسية، باردة، لا تنحني أمام حاجة الفقراء ولا خوف الأطفال.
بوابة مغلقة في الوعي قبل أن تكون مغلقة في الرسم.
بوابة تصنع الفصل بين “من ينتظر” و“من يعاني”، بين “داخل” و“خارج”، مع أن الواقع لا يعرف فعلًا أين الداخل وأين الخارج.
هذه البوابة ترمز إلى:
-
سلطة تعجز عن حماية الناس
-
حدود تُفرض ولا تُناقش
-
قرارات تُصنع خلف جدران لا يصلها صوت الشعب
-
وقوف الناس على عتبة وعود لا تتحقق
إنها بوابة تقول:
“ستبقون هنا… في منطقة الانتظار.”
خامسًا: الأبيض… مساحة المعنى المفتوح
الغريب في هذه اللوحة أن البياض ليس نقصًا؛ إنه لغة.
الفراغات تلعب دورًا نفسيًا فاعلًا:
هي فجوة الوجود، الفراغ بين السؤال والجواب،
الفراغ الذي يعيشه الفلسطيني بين وطنٍ يُسرق وواقعٍ يضغط.
الأبيض هنا يحمل كل ما لم يُرسم.
يحمل الماضي الذي فقدناه، والمستقبل الذي نخشى أن لا نصله.
سادسًا: التوتر بين الفرد والجماعة… الرواية التي لا تُروى
الرجل الجالس والحشد المتدافع لا يتبادلان النظر.
هذا الانفصال البصري ليس خطأً؛ إنه جزء من الفكرة:
-
الرجل يمثل الحكمة المنكسرة
-
الحشد يمثل الطاقة المكسورة
والحياة الفلسطينية تتحرّك دائمًا بين هاتين القوتين:
الخبرة التي تعبت، والجموع التي تصرخ.
كأن الفنان يهمس:
“الأمّة تتحرك…
لكن الفرد ينطفئ.”
أو ربما:
“الألم هنا ليس ملكًا لأحد…
إنه جماعيّ.”
سابعًا: الصحن أمام الرجل… الهزيلة المعلّقة بين الحياة والكرامة
صحن صغير، متواضع، شبه فارغ.
تفصيل صغير لكنه يحمل دلالات بحجم القضيّة:
-
الجوع
-
الندرة
-
انتظار الصدقة
-
انتظار تسوية سياسية
-
انتظار العدالة
-
انتظار من لا يأتي أبدًا
الصحن يشبه وطنًا مقسومًا،
يُمدّ فيه للشعب القليل… القليل جدًا…
بينما الضجيج خلفه يعد بالكثير ولا يعطي شيئًا.
ثامنًا: لماذا هذه اللوحة مؤلمة إلى هذا الحد؟
لأنها تصوّر لحظة يعرفها كل فلسطيني:
لحظة الانتظار.
لحظة الوقوف على أعتاب المجهول.
لحظة الإيمان الذي يتآكل لكن لا يموت.
لحظة الاحتجاج الذي لا يسمعه أحد.
لحظة الأمل الذي يأتي من طفل يطلّ برأسه من خلف رجلٍ مرهق.
هذه اللوحة ليست واقعية…
إنها وجوديّة،
تتجاوز المكان لتصوّر “حالة شعب”،
وتتجاوز الزمان لتعيد تكرار السؤال نفسه:
متى تفتح هذه البوابة؟
ومتى يستطيع الرجل أن يقف بدل أن يجلس؟
ومتى يتقدّم الطفل بدل أن يختبئ خلف ظهرٍ منهك؟
الخلاصة: لوحة تُشبه شعبًا بأكمله
هي ليست مشهدًا عابرًا، بل شهادة.
شهادة على صراع الإنسان مع الجدار،
وصراع الإنسان مع ذاته،
وصراع الإنسان مع الانتظار الطويل الذي يفتك بالروح كما يفتك بالوقت.
إنها لوحة تقول كل ما لا يُقال،
وتفتح جرحًا أوسع مما نرى،
وتمنحنا على الرغم من قسوتها…
أملًا صغيرًا يشبه وجه طفل يطلّ من خلف رجلٍ هرم.